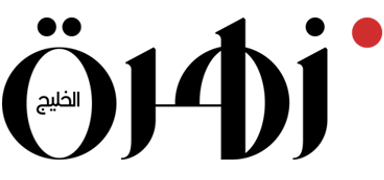#ثقافة وفنون
نجاة الظاهري الخميس 12 سبتمبر 2024 18:00
ثمانية فنانين ناشئين، يعرضون تجاربهم المتميزة، ضمن برنامج الإقامة «سبيكتروم» في منارة السعديات - أبوظبي، تحت عنوان «في الإطار»، والذي يأتي هذا العام تتويجاً للنسخة الأولى منه. ففي هذا المعرض الفريد، يلتقي الضوء بالصوت؛ لتقديم تجربة فنية فريدة، تقود الزائر إلى عالم من التفسيرات المختلفة.. الفنان والقيّم الفني، ناصر عبد الله المازمي، هو من يقف وراء هذه التجربة الإبداعية، حيث اختار الفنانين، ونسق في ما بينهم؛ لتقديم أعمال تعكس رؤيتهم الخاصة.. في هذا الحوار، يحدثنا المازمي عن تجربته كفنان، وكيفية انتقاله إلى «التقييم الفني»، ورؤيته الخاصة للفن، وكيفية تقديمه:
-

ناصر عبد الله المازمي: الفن وسيلة لإثارة التساؤلات والتفكير
بدايةً.. حدثنا عن ناصر الفنان قبل القيّم!
بدأت رحلتي فناناً تشكيلياً، لأنني كنت أمارس الرسم في بداياتي. وقد تطورت موهبتي بعد الالتحاق بدورات فنية في «المرسم الحر»، تحت إشراف الفنان محمد كاظم. وكان يرافقنا، آنذاك، الفنان الراحل حسن شريف. بمرور الوقت، تطورت تجربتي الفنية بشكل كبير، وحققت مكانة جيدة. لاحقاً، وبسبب ظروف خاصة، اتجهت إلى تقييم الأعمال الفنية. وقبل أن أصبح قيّماً، ترأست إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وكنت ضمن مجلس إدارتها لفترة طويلة، وختمت رحلتي فيها رئيساً للمجلس بين عامَيْ: 2015، و2018، كما كنت رئيس تحرير مجلة «تشكيل»، التي تصدر عن «الجمعية»، والتي أراها مشروعاً ذا أهمية كبيرة، فقد كانت من مصادر الفنون التشكيلية القليلة في الإمارات. وقد منحني وجودي بالإدارة الفرصة لأدخل مجال التقييم، فهذا البحر ذو خلفية تاريخية ممتدة إلى المرحلة البرجوازية الأوروبية، حيث كانت لدى الأثرياء مقتنيات فنية، تحتاج إلى من يديرها. ومن هنا كانت البداية، التي أبرزت وظيفة الشخص المسؤول عن ترتيب المقتنيات في المتحف، أو المجموعات الشخصية، واختيارها، ووضع القصة الخاصة بها في مساحة عرضها.
لكل فنان قصة
حدثنا عن دورك كقيّم في المعارض الفنية!
القيّم الفني يبحث في موضوع المعرض، ومجاله، ولكل معرض ظروفه واحتياجاته، فالمقيّم هو الشخص الذي يحبك القصة، التي تجمع بين الفنانين المشاركين في المعرض. وكل فنان له قصته، التي يرغب في طرحها من خلال عمله، فالقيم يُوجد الرابط بين الفنانين، الذي يمكن اعتباره شكلاً من أشكال النقد الفني، فأنا مكلف باختيار مجموعة فنانين، ووضعهم في معرض معين، وبالتالي أختار نوعية معينة لإنتاج أعمال معينة، وأسعد آخرين، كجزء من عملية التقييم، فلا أكتب نصّاً أنتقد فيه أحداً، وإنما أضع عمله في معرض.
-

ناصر عبد الله المازمي: الفن وسيلة لإثارة التساؤلات والتفكير
ماذا عن تجربة إقامة «سبيكتروم»، ومعرضها الحالي؟
في هذا المعرض، تحديداً، كان التركيز على المصورين الفوتوغرافيين؛ فالتصوير من الأدوات التي يصعب تحويلها إلى أعمال فنية متكاملة، خاصة إذا كان المصور يرى نفسه مصوراً وليس فناناً، فالشكل المتعارف عليه في المعارض هو التقاط صورة، ووضعها داخل إطار. لذلك، كان التحدي هو إخراج المصورين من منطقة راحتهم، وإيجاد طرق لعرض أعمالهم بشكل غير تقليدي، حتى لا تكون مجرد صور داخل إطارات؛ فكان من الضروري تحفيزهم على الخروج بأفكار جديدة. فلو تحدثنا عن محمد العلوي مثلاً، صاحب عمل «جسر، رحلة إلى خط البداية»، كان التحدي في كيفية إخراجه من قالب المصور التقليدي، وزينب الهاشمي كذلك، في عملها «وهو معكم»، فقد كانت تجربتها قائمة على مراقبة الآخرين، والأشياء الموجودة في المدينة، كهذه النافذة المفتوحة مثلاً، وتلك المغلقة، وعمّا يتحدث الناس، فهذا جزء من دور المقيّم، لذا يجب أن يكون لديه مخزون بصري ومعرفي جيد؛ ليفتح حواراً بينه وبين الفنان، يستطيع من خلاله أن يتحداه في بُعد معين، أو يطرح سؤالاً معيناً، يضع الفنان في حالة شك، ليمنحه القدرة على تكوين الفكرة، والعمل الفني. حواري مع الفنانين امتد من يناير حتى أبريل، وكنا خلال هذه المدة نتحاور، وكل منا يخرج بطريقة ما للإجابة على الأسئلة، حتى بدأت الأفكار تترابط لديه، لينتج عمله المعروض حالياً.
-

ناصر عبد الله المازمي: الفن وسيلة لإثارة التساؤلات والتفكير
تجارب مترابطة
المعرض يضم أعمالاً متنوعة، مثل: الأقمشة، والمرايا، والمربعات المضيئة.. كيف ترى ترابط هذه التجارب؟
رغم تنوع الأعمال، إلا أننا نجد أن كلاً منها يحمل جانباً شخصياً، يتجاوز التجربة الفردية؛ لتشمل معاني أوسع. مثلاً، نجد أن لدى ندى الموسى تجربة شخصية مع أجدادها الذين عاصرتهم. أما محمد العلوي، فهو تجربة أخرى في المدينة. وروضة المزروعي وفيلمها «مهيّر»، الذي تعرض من خلاله ارتباطها بمنطقة «سيجي» رغم أنها مقيمة بأبوظبي، فارتباطها بهذه المنطقة كان له بُعد شخصي، وذاكرة معينة، أوسع من مجرد تجربة شخصية. أما فيصل الريّس، فمن خلال عمله التركيبي «متاهة الأرواح»، كان يحاول خلق حالة تجعل من يشاهد العمل يتساءل. فالفكرة من العمل الفني، بشكل عام، هي إثارة تساؤل، ونحن من خلاله لا نحل مشكلة، ولا نوجه، ولا نعظ، بل نثير أسئلة، وهو ما أراد فيصل عمله، بوضع مرايا مختلفة الأوجه. كان يريد أن يرى الناس أنفسهم، وكم هم متشابهون، ومحتاجون إلى شيء من الحب والتسامح والتواصل معاً، بتركيزه أكثر على المشاعر، فالمرء يرى نفسه جيداً؛ إذا كانت المرآة مستقيمة، وليس كذلك إن كانت معوجة. أما زايد الهدار، فإنه كان مصوراً للأزياء وعروضها، وفي عمله «دارنا» استخدم قطع الملابس التقليدية للنساء الإماراتيات لصنع الخيمة، وكذلك بعض قطع الأثاث المعبرة عن الثقافة المحلية.
-

ناصر عبد الله المازمي: الفن وسيلة لإثارة التساؤلات والتفكير
هل هناك أعمال متميزة، أو تحديات معينة، واجهتها مع الفنانين المشاركين؟
كل فنان شارك في المعرض قدّم تجربة فريدة، ولكل منهم تحدياته. فمثلاً، محمد كان مصوراً للحياة اليومية، ما جعله مرتبطاً بالمدينة وتفاصيلها التي تمر عليه بشكل يومي، وكانت إحدى صعوباته إظهاره أمام الكاميرا لا خلفها؛ ليصور نفسه شخصياً. أما ندى فخلفيتها أكاديمية، فهي خريجة كلية الآداب، والمحتوى الذي قدمته أرشيفيّ بشكل أكبر، وروضة خريجة «فنون جميلة» من جامعة نيويورك أبوظبي، وعملها كان جزءاً من مشروع تخرجها، ولم تكن راغبة في العمل على الموضوع ذاته. أما زينب، فعملها به جانب روحاني، وأحبت إضافة هذا البعد إلى عملها، وهو بُعد ليس من السهل العمل عليه في مساحة حداثية.
ميفان مكية، في عملها «فهي ليست نفس الأرض، وأنا لست نفس الشخص»، الذي أنتجته بعد زيارتها إلى العراق، وهي صانعة أفلام سينمائية عراقية كردية كندية، ولم تزر بلدها الأم لفترة طويلة. وخلال البرنامج، زارته، وجمعت ما تستطيع جمعه من حكايات وتذكارات، فموضوعها، كان الأمور التي تستطيع أن تجمعها وتأخذها معها كذكرى من بغداد، صاحبة الحضارة والعمق التاريخي. وآخرهم مارك أنطوني أجتاي، صاحب عمل «جدران الهوية»، فقد صور الجدران والناس من الخلف، وكان من أصعب من ناقشناهم، وقد أخبرنا بأن لديه جداراً في منزله، يحتفظ عليه بأشياء يحبها، وظل رافضاً نقل هذا الجدار إلى المعرض؛ لارتباطه الشخصي به، فأدرنا معه حواراً عن كل جدران العالم، من سور الصين العظيم، حتى جدار برلين، إلى أن خرج بفكرة تصوير الناس، وهم يقفون أمام جدران مسجد الشيخ زايد الكبير، وجمالياتها المتميزة.
-

ناصر عبد الله المازمي: الفن وسيلة لإثارة التساؤلات والتفكير