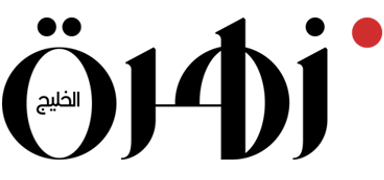#مقالات رأي
لولوة المنصوري 4 يوليو 2024
خلدت الإنسانية مخزوناً عظيماً من الحكايات والأمثال، التي وردت على ألسنة الحيوانات، فقد تجلت تلك الملامح في الحكمة، والتصوف، والروحانية، مثل: رسائل إخوان الصفا، ومنظومة «منطق الطير» لفريد الدين العطار، وفي الحكايات الشهيرة لـ«كليلة ودمنة»، و«ألف ليلة وليلة»، وغيرها من كتب التراث.
لاشك في أن هناك أبعاداً أنطولوجية، وتجربة «جوانية» متجذرة في الذات الإنسانية، تدفعنا نحو الكتابة على لسان الحيوان، فهي أبعاد أكبر من كونها حلاً رقابياً اجتماعياً وسياسياً، أو استعراضاً فلسفياً، وأبعد من كونها حمّالة لحلول وحكمة وموعظة، إن السؤال الجوهري، الذي لابد منه: لماذا يستعير الكاتب، الراوي، والرسّام لسان الحيوان وشأن حياته ومجتمعه؟
قد تكون للعجائبية والمتافور والرموز الدلالية متعة تشويقية، كامنة في سحر التأويل والمدلولات الحُرّة. إن مجرد وضع العظة والحكمة في مسار البحث عن تأويلات السرد والحكاية من شأنه أن يقتل الحكاية نفسها، ويغلق المسار التخيلي، المدعوم بالدهشة والترقب والسعة الدلالية. وقد تكون الكتابة على لسان الحيوان شكلاً من الحنين إلى الطبيعة والحياة الفطرية، ومعايشة المخلوقات، ومنحها أسماءً وصفات، خاصة في مجتمعات الأبنية والجدران والحدود، على اعتبار أن مجتمع الحيوان بلا حواجز (مادية)، أو (فكرية عقلية)، فالحواجز من صنع الفكر البشري، والحاجز تفسير آخر لمدلول الخوف، وعدم التوازن مع الطبيعة، وما تزخر به من ماورائيات وأحداث مبهمة.
يحن الإنسان لأن يعيش، أحياناً، وفق طبيعة (اللاعقل)، ووفق شريعة التسليم التام، الحُرّة من التخطيط والتعصب والتوترات والأوهام وسجون الذاكرة. وثمة بُعدٌ روحيٌّ أيضاً؛ فالكتابة على لسان الحيوان تخفف من ثقل التجربة الإنسانية، الموسومة دائماً باللوم والذنب والعار، تلك المشاعر التي ما انفكّت تؤثث الأرض على الصدمات والكارما والخوف من الزمان والمصائر.. وتورِّث (هاجس البقاء) المبني على مخاوف العقل وأوهامه. بينما الحيوان حُرٌّ من كل ذلك، يعيش وفق التسليم التام، و(غريزة البقاء) النابعة من الطبيعة نفسها.